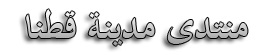ريع اللصوص
علي الطنطاوي (ت 1420هـ - 1999 م)
نُشر عام 1986م
تمنيت لو أن اللصوص والمفسدين في الأرض اجتمعوا في مكان محصور، إذَنْ لهان الوصول إليهم وإصلاحهم أو القضاء عليهم. ولو اجتمع البعوض كله في موضع واحد لقضي على البعوض؛ لأن نجاته في تفرقه واختفائه، وأنه يضرب ويهرب ويضر ويفر فلا يوصل إليه.
وشرٌّ من الحشرات والبعوض وجراثيم الأمراض قوم بيغن وشامير، واجتماعهم في فلسطين من بشائر القضاء عليهم، وأن نرى تأويل قوله تعالى فيهم، وقوله الحق: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا} [الإسراء : 4 ، 5]
والأولى التي بعث الله عليهم عباده المؤمنين به المخلصين له هي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، الذين جاسوا خلال الديار التي حسبوها يوماً ديارهم (في المدينة)، ثم أُجلوا عنها وعن جزيرة العرب فلن يعودوا بعون الله إليها.
{ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا} [الإسراء : 6]؛ وهذا ما نراه الآن، حين اجتمع في أيدي اليهود –على قلتهم- أمضَى السلاح، وناصرهم أقوى الدول، وجعلهم الله أكثر نفيراً في الحرب. ولكن الله يمهد بذلك للمسلمين - إن عادوا إلى دينهم - ليسوؤوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة.
وسنرى تأويل هذا عياناً ونرى تحقيق ما خبَّر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي فاقتله)؛ أي أننا سنقف أمامهم في المعركة التي يكون الظفر فيها لنا عليهم، فكيف نظفر بهم وهم متفرقون في البلدان مندسون بين الشعوب؟ وهل يكون القتال إلا بين جماعتين ظاهرتين؟ فاجتماعهم في فلسطين وقيام دولتهم فيها تصديق لوعد الله ورسوله لنا.
ولا تعجبوا من نطق الشجر والحجر. ألم يعلمنا الله كيف ننطق الأسطوانة وشريط التسجيل والرائي (التلفزيون)؟ ألم ينطق لنا الجماد؟ فلماذا تعجبون ولا تكادون تصدقون إن سمعتم أن الشجر والحجر ينطقان؟
وهذا وعد من الله لنا إن عدنا إلى ديننا وجعلنا معركة فلسطين معركة إسلامية، لا معركة استرداد الأرض فقط، فكل شعب تسلب أرضه يحارب لاسترداد أرضه، ولا معركة قومية عربية، لأن لغيرنا قوميات، فإن اعتمدنا على القومية وحدها صرنا نحن وهم سواء ووكلنا الله – كما وكلهم – إلى أنفسنا، وإن تخلَّى الله عنا ووكلنا إلى أنفسنا ضعنا.
إن معهم وعد بلفور، وهذا وعد من رب بلفور الذي خلقهم وخلق بلفور، وسيقفون بين يدي رب العالمين يوم لا ينفع المال ولا السلاح، يوم تبرز الجحيم لمن يرى، فمن ينقذهم يومئذ منها؟
وهذا، ولا تقولوا لي: قد خرجت عن الموضوع؛ فإن موضوعي اليوم هو الكلام عن اللصوص، أثاره في نفسي وقوفي في المكان الذي كان يسمَّى يومئذ (ريع اللصوص). وأكبر لصوص العصر وأعظمهم جرماً وأشدهم إثماً اليهود الذين هم اليوم في فلسطين.
وإذا كان من يسرق متاعاً من الدار يكون من المجرمين الفجار، فكيف بمن يسرق الدار كلها؟ وكيف بالذي يُعينه على جريمته، ويكون معه على صاحب البيت؟ ألا يكون مجرماً مثله؟ فكيف بمن يسرق قُطراً كاملاً، يأخذه من أهله، يحتله بسلاح البغي والعدوان، ثم إذا قام من أصحابه من يطالب بحقه فيه أحالوه إلى المحكمة بتهمة مقاومة الاحتلال؟ أرأيتم أجرأ على الحق من هذا؟ أرأيتم من هو أصفق وجهاً وأوقح نفساً من اللص الذي ينكر عليك أن تطالب بحقك؟
وإذا جاء من يزعج المحتل بكى وشكا، وقال: إنه يريد أن يكون آمناً، وهذا يذهب أمنه ويفسد عليه حياته!
ولو أنني حصرت ذهني لجمعت مما عرفت من أخبار اللصوص كتاباً صغيراً، ولو أن أحد المؤلفين يضع كتاباً في طبقاتهم وأخبارهم لجاء منه أثر أدبي تاريخي، ولا تعجبوا، فإن أجدادنا ألفوا في سير العلماء والدعاة والمصلحين والعقلاء والمجانين واللصوص والمجرمين، ونحن نزعم أننا نعيش في عصر النور فلا نفعل عشر ما فعلوا.
ولعل أدنى طبقاتهم وأيسرها (لو أن في السرقة يسيراً!) هو الذي يسرق عن حاجة، يسرق ليعيش. وشرٌّ منه الذي يسرق طمعاً واستكثاراً من المال بالحرام، والذي يسرق متستراً بجاهه أو منزلته أو ثقة الناس به، والمحتال والمزور، والذي يأكل مال الأرملة واليتيم، وينسى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً. والذي يستهين بسرقة أموال الدولة، ابتداء من صحيفة الورق الصقيل يكتب في وسطها رقم هاتف أو عنوان صديق، ومن استعمال سيارة الدولة في خاصة شأنه وشأن أسرته، وانتهاء بالذي يسرق أموال المناقصات والتعهدات. وهذا كله من (الغلول) الذي توعد الله فاعله وقال عنه: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران : 161] فمن أين له يوم القيامة مثل ما غله وسرقه ليأتي به؟
والذي يسرق وقت العمل؛ يكلف بأن يجيء الساعة الثامنة فيجيء التاسعة، وأن يخرج في الثانية فيخرج في الواحدة، ويمضي باسمه على دفتر الدوام ثم ينسل فيغيب ساعة أو بعض ساعة. والذي يسرق أوقات المراجعين وكرامتهم، فتكون القضية محتاجة إلى خمس دقائق فيقول لصاحبها: تعالَ غداً، يحسب أنه إن قعد وراء المكتب والمراجع واقف أمامه أن ذلك سيدوم له، ثم يدعي أنه مؤمن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
والتلميذ الذي يسرق الجواب في الامتحان. إنه حين يسرق بعينه من ورقة جاره أكبر ذنباً من الذي يسرق بيده من جيبه؛ لأن سرقة المال يزول أثرها بردِّ المال، ومن سرق الجواب ونال الدرجة زوراً، ثم أخذ بعدها الشهادة زوراً، ثم نال المنصب زوراً، يستمر أثر جريمته دهراً، وربما صار بشهادته معلماً وهو غير عالم، فنشأ على يديه الآثمتين جماعة من الجهلاء، فيكون كحامل جرثومة المرض يعدي من يتصل به، ومن أعداه ذهب فأعدى سواه، فسرى المرض في جسد الأمة.
أما السرقات الأدبية فلها حديث قديم جدًّا طويل جدًّا، كتبت فيه في غير هذا الموضع، وقد ظهر الآن لون منها ما عرفه الأولون هو سرقة المطبوعات. وقد تجرَّعت منه المرَّ وذقت منه الصَّابَ والعلقم. آخذ كتابي المطبوع بإذني وعلمي والكتاب المسروق، فلا أميز أنا واحداً من واحد؛ لأن الورق هو الورق والحرف هو الحرف والحبر هو الحبر! لكني إن لم أستطع أن أميز فإن في الوجود من يميز الصالح من الفاسد، ومن يكافئ على الحسن، ويعاقب على السيئ، هو الله الذي سيقف بين يديه الظالم والمظلوم. وربما أحسن إليَّ هذا الذي سرق كتبي؛ لأنني آخذ منه حقي يوم يُلغى التعامل بالريال وبالدولار وباليِنِّ وبالمارك، ولا يبقى إلا التعامل بالحسنات، فمن كان له حق أخذ من حسنات من عليه الحق، أو ألقي عليه من سيئاته.
ومن السرقات ما لا يعوض. كان في متحف دمشق مجموعة من الدنانير الأموية بقيت بعد هذا الزمان الطويل وقلَّ أمثالها، سرقها مرة لص فأذابها وجعلها سبيكة فأضاع قيمتها التاريخية، وإن حفظ كتلتها الذهبية؛ كالذي سرق دفتري في رحلة الحجاز، وقد حدثتكم خبره، ودفتراً آخر ضخماً كتبت فيه بخطي مباحث علم النفس والفلسفة لما كنا ندرسها سنة 1929 (1348هـ)، وكان عزيزاً عليَّ؛ لأن فيه فصلاً من تاريخ حياتي، ولأن فيه قطعة من نفسي، لست أدري مَن سرقه من بيتي. وما سرقه لصٌّ محترف تسلَّق الجدار أو كسر الأقفال، ولكن سرقه واحد ممن أدخلته أنا داري، لا يعلم إلا الله وحده من هو.
ومن اللصوص الذين يستعيرون الكتب ولا يردونها، لذلك قررت قراراً لا رجعة فيه أن لا أعير أحداً كتاباً مهما كان السبب:
ألا يا مستعير الكتب دعني
فإن إعارتي للكتب عار
فمحبوبي من الدنيا كتابي
وهل أبصرت محبوباً يعار؟
ومن اللصوص الذين لا يؤبه لهم الذين يسرقون وقتك؛ فيأتي من يزورك على غير ميعاد، يهبط عليك كما تهبط المصيبة، وينزل بك كموت الفجأة. ولطالما عطَّل عليَّ مثل هؤلاء مقالة كنت أعدها، أو درساً كنت أحضره. لذلك لا أستقبل الآن أحداً أبداً بلا موعد، لا كبراً مني ولكن حفاظاً على وقتي. وإذا كانت سرقة المال ذنباً، فسرقة الوقت الذي يأتي بالمال أكبر؛ الوقت الذي تنال به المال والعلم، ويكون سبباً في دخوله الجنة أو في دخولك النار.
على أن هذا كله يعدُّ في مجتمعاتنا من الشواذِّ، والأصل في الناس الاستقامة والخير...
وبعد، فإني سأورد عليكم طرفتين من طرف اللصوص فيهما إن شاء الله متعة:
في دمشق مسجد كبير اسمه (جامع التوبة)، وهو جامع مبارك فيه أنس وجمال، سمِّي بجامع التوبة؛ لأنه كان خاناً ترتكب فيه أنواع المعاصي، فاشتراه أحد الملوك في القرن السابع الهجري وهدمه وبناه مسجداً. وكان فيه - من نحو سبعين سنة- شيخ مربٍّ عالم عامل اسمه الشيخ سليم المَسْوَتي، وكان أهل الحي يثقون به، ويرجعون إليه في أمور دينهم وأمور دنياهم. وكان عند هذا الشيخ تلميذ صالح، وكان مضرب المثل في فقره وفي إبائه وعزة نفسه، وكان يسكن في غرفة في المسجد. مرَّ عليه يومان لم يأكل فيهما شيئاً، وليس عنده ما يَطعمه، ولا ما يشتري به طعاماً، فلما جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على الموت، وفكَّر ماذا يصنع، فرأى أنه بلغ حد الاضطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة، فآثر أن يسرق ما يقيم صلبه.
وهذه القصة واقعة، أعرف أشخاصها، وأعرف تفصيلها، وأروي ما فعل الرجل، لا أحكم على فعله بأنه خير أو شر أو أنه جائز أو ممنوع. وكان المسجد في حيٍّ من الأحياء القديمة، والبيوت فيها متلاصقة والسطوح متصلة، يستطيع المرء أن ينتقل من أول الحي إلى آخره مشياً على السطوح. فصعد إلى سطح المسجد، وانتقل منه إلى الدار التي تليه، فلمح فيه نساء فغضَّ من بصره وابتعد، ونظر فرأى إلى جنبها داراً خالية، وشمَّ رائحة الطبخ تصعد منها، فأحس مِن جوعه لما شمَّها كأنها مغناطيس يجذبه إليها. وكانت الدور من طبقة واحدة، فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة فصار في الدار، وأسرع إلى المطبخ فكشف غطاء القدر، فرأى فيها باذنجاناً محشواً، فأخذ واحدة ولم يبال من شدة جوعه بسخونتها، وعض منها عضة، فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه، وقال لنفسه: أعوذ بالله، أنا طالب علم مقيم في المسجد، ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها؟
وكبر عليه ما فعل، فندم واستغفر وردَّ الباذنجانة، وعاد من حيث جاء، فنزل إلى المسجد وقعد في حلقة الشيخ، وهو لا يكاد – من شدة الجوع - يفهم ما يسمع. فلما انقضى الدرس وانصرف الناس (وأؤكد لكم أن القصة واقعة) جاءت امرأة مستترة (ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستترة) فكلَّمت الشيخ بكلام لم يسمعه، فتلفَّت الشيخ حوله فلم يرَ غيره، فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟ قال: لا. قال: هل تريد الزواج؟ فسكت، فقال له الشيخ: قل، هل تريد الزواج؟ قال: يا سيدي، ما عندي ثمن رغيف آكله فلماذا أتزوج؟
قال الشيخ: إن هذه المرأة خبَّرتني أن زوجها توفي، وأنها غريبة عن هذا البلد، ليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عمٌّ عجوز فقير، وقد جاءت به معها (وأشار إليه قاعداً في ركن الحلقة) وقد ورثت دار زوجها ومعاشه، وهي تحبُّ أن تجد رجلاً يتزوجها على سنة الله ورسوله؛ لئلا تبقى منفردة فيطمع فيها الأشرار وأولاد الحرام، فهل تريد أن تتزوج بها؟ قال: نعم. وسألها الشيخ: هل تقبلين به زوجاً؟ قالت: نعم.
فدعا بعمِّها، ودعا بشاهدين، وعقد العقد، ودفع المهر عن التلميذ، وقال له: خذ بيد زوجتك.
فأخذ بيدها، أو أخذت هي بيده، فقادته إلى بيتها، فلما دخلته كشفت عن وجهها فرأى شباباً وجمالاً، ورأى البيت هو البيت الذي نزله. وسألته: هل تأكل؟ قال: نعم.
فكشفت غطاء القدر فرأت الباذنجانة، فقالت: عجباً! من دخل الدار فعضَّها؟
فبكى الرجل وقصَّ عليها الخبر، فقالت له: هذه ثمرة الأمانة، عففت عن الباذنجانة الحرام فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال.
أما القصة الأخرى فلعل الطرافة فيها أكثر من المنفعة منها، وهي واقعة أعرف أشخاصها وظروفها، هي أن شابًّا فيه تقًى وفيه غفلة طلب العلم، حتى إذا أصاب منه حظًّا قال الشيخ له ولرفقائه: لا تكونوا عالة على الناس، فإن العالم الذي يمدُّ يده إلى أبناء الدنيا لا يكون فيه خير، فليذهب كل واحد منكم وليشتغل بالصنعة التي كان أبوه يشتغل بها، وليتقِ الله فيها.
وذهب الشاب إلى أمه فقال لها: ما هي الصنعة التي كان أبي يشتغل بها؟ فاضطربت المرأة وقالت: أبوك قد ذهب إلى رحمة الله، فما لك وللصنعة التي كان يشتغل بها؟ فألحَّ عليها وهي تتملص منه، حتى إذا اضطرها إلى الكلام أخبرته- وهي كارهة- أن أباه كان لصًّا.
فقال لها: إن الشيخ أمرنا أن يشتغل كلٌّ بصنعة أبيه ويتقي الله فيها.
قالت الأم: ويحك! وهل في السرقة تقوى؟
وكان في الولد كما قلت غفلة، فقال لها: هكذا قال الشيخ.
ثم ذهب فسأل وتسقَّط الأخبار حتى عرف كيف يسرق اللصوص، فأعدَّ عُدَّة السرقة، وصلَّى العشاء، وانتظر حتى نام الناس، وخرج ليشتغل بصنعة أبيه كمال قال الشيخ. فبدأ بدار جاره، ثم ذكر أن الشيخ قد أوصاه بالتقوى، وليس من التقوى إيذاء الجار، فتخطَّى هذه الدار. ومر بأخرى فقال لنفسه: هذه دار أيتام، والله حذَّر من أكل مال اليتيم، وما زال يمشي حتى وصل إلى دار تاجر غني ليس له إلا بنت واحدة، ويعلم الناس أن عنده الأموال التي تزيد عن حاجته.
فقال: هاهنا. وعالج الباب بالمفاتيح التي أعدها ففتح ودخل، فوجد داراً واسعة وغرفاً كثيرة، فجال فيها حتى اهتدى إلى مكان المال، وفتح الصندوق فوجد من الذهب والفضة والنقد شيئاً كثيراً، فهمَّ بأخذه، ثم قال: لا، لقد أمرنا الشيخ بالتقوى، ولعل هذا التاجر لم يؤد زكاة أمواله، لنخرج الزكاة أولاً.
وأخذ الدفاتر وأشعل فانوساً صغيراً جاء به معه، وراح يراجع الدفاتر ويحسب، وكان ماهراً في الحساب خبيراً بإمساك الدفاتر، فأحصى الأموال وحسب زكاتها فنحَّى مقدار الزكاة جانباً، واستغرق في الحساب حتى مضت ساعات، فنظر فإذا هو الفجر. فقال: تقوى الله تقضي بالصلاة أولاً.
وخرج إلى صحن الدار، فتوضأ من البركة وأقام الصلاة، فسمع رب البيت فنظر فرأى عجباً، فانوساً مضيئاً، ورأى صندوق أمواله مفتوحاً ورجلاً يقيم الصلاة. فقالت له امرأته: ما هذا؟ قال: والله لا أدري! ونزل إليه فقال: ويلك من أنت وما هذا؟ قال اللص: الصلاة أولاً ثم الكلام، فتوضأْ ثم تقدَّمْ فصلِّ بنا، فإن الإمامة لصاحب الدار.
فخاف صاحب الدار أن يكون معه سلاح ففعل ما أمره به، والله أعلم كيف صلَّى، فلما قضيت الصلاة قال له: خبِّرني ما أنت وما شأنك؟ قال: لص. قال: وماذا تصنع بدفاتري؟ قال: أحسب الزكاة التي لم تخرجها من ست سنين، وقد حسبتها وفرزتها لتضعها في مصارفها. فكاد الرجل يُجنُّ من العجب، وقال له: ويلك، ما خبرك؟ هل أنت مجنون؟ فخبَّره خبره كله. فلمَّا سمعه التاجر، ورأى جمال صورته وضبط حسابه ذهب إلى امرأته فكلَّمها، ثم رجع إليه فقال له: ما رأيك لو زوَّجتك بنتي، وجعلتك كاتباً وحاسباً عندي، وأسكنتك أنت وأُمَّك في داري، ثم جعلتك شريكي؟ قال: أقبل. وأصبح الصباح فدعي بالمأذون وبالشهود وعقد العقد!
وهذه قصة واقعة.
وأما السرقات الأدبية فقد قلت لكم إنني لا أعرض لها الآن، إلا واحدة لها صلة بالعلم والعلماء، وهي سرٌّ لم يرفع عنه الستار إلى الآن. ذلك أن عندنا كتابين متماثلين تماماً في موضوع جديد، لم يؤلف فيه قبلهما ولم يؤلف فيه بعدهما إلا القليل، هما كتاب (الأحكام السلطانية) للماوردي وكتاب (الأحكام السلطانية) للقاضي أبي يعلى. والكتابان متشابهان متطابقان؛ لأن أحدهما منسوخ عن الآخر، فمن هو صاحب الكتاب الأول؟
الماوردي من أفقه فقهاء الشافعية وكان يُلقَّب بأقضى القضاة، وأبو يعلى من أفقه فقهاء الحنابلة، وإذا قيل (القاضي) انصرف اللقب إليه. والاختلاف بينهما أن الماوردي حين يسرد الأحكام يسردها على المذهب الشافعي، وأبو يعلى على مذهب الإمام أحمد. وكانا في عصر واحد، وبلد واحد، وأظنهما كانا قاضيين في محكمة واحدة!
فلعل أحد الأساتذة أو الطلاب الذين يعدون رسائل الشهادات العالية يدرس هذا الموضوع، ويثبت بالأدلة من منهما المؤلف الأول. أما أنا فأميل إلى أنه الماوردي، لأن للماوردي كتاباً آخر قريباً في أسلوبه ونهجه وطريقته من هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب.
المصدر: فصول في الثقافة والأدب للشيخ علي الطنطاوي، جمع وترتيب مجاهد مأمون - دار المنارة، ط1، 2007هـ (ص 12) بتصرف