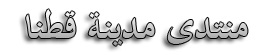تابع جبل الشيح - جبل الرؤى - 2
ونعود فنقول إن الرؤى لها دور هام في التاريخ البشري ، ولأهميتها الكبرى فإن الله تعالى قص علينا عددًا منها في القرآن الكريم ، فقد قص ثلاث رؤى علينا في سورة واحدة ، رؤيا يوسف – عليه السلام – ورؤيا السجينين ، ورؤيا فرعون مصر ، وقبل ذلك قص رؤيا إبراهيم - الجد الأول ليوسف – عليه السلام – وبعد ذلك بعض رؤى الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم - وذلك لتكون نموذجًا حيًّا لتلك الرؤى التي تحدث لكثير من الناس ، ولكن رؤى الأنبياء حق ووحي ، بخلاف رؤى الناس . قال الله تعالى في كتابه الكريم عن الرؤيا الأولى : « رؤيا إبراهيم » – عليه السلام –: « فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ : يَا بُنَيَّ ! إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ؟ قَالَ : يَا أَبَتِ ! افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ، سَتَجِدُنِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا . إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ »( ). قال الشنقيطي : اعلم أوّلاً : أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم في المنام بذبحه ، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي ، ثم لمّا باشر عمل ذبحه امتثالاً للأمر، فداه اللَّه بذبح عظيم ، هل هو إسماعيل أو إسحاق ؟ .. اعلم - وفّقني اللَّه وإياك - أن القرآن العظيم قد دلّ في موضعين ، على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق . أحدهما : في « الصافّات » ، والثاني في « هود » . أمّا دلالة آيات « الصافّات » على ذلك ، فهي واضحة جدًا من سياق الآيات ، وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيّه إبراهيم : « وَقَالَ : إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »( ) ، قال بعد ذلك عاطفًا على البشارة الأولى : « وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ »( ) ، فدلّ ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشّر به في الثانية ؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب اللَّه على أن معناه : فبشرناه بإسحاق ، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا : « وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ »( ) ، فهو تكرار لا فائدة فيه ينزّه عنه كلام اللَّه ، وهو واضح في أن الغلام المبشر به أوّلاً الذي فدي بالذبح العظيم ، هو إسمعيل ، وأن البشارة بإسحاق نصّ اللَّه عليها مستقلّة بعد ذلك . وقد أوضحنا في سورة « النحل » ، في الكلام على قوله تعالى : « مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً »( ) ، أن المقرّر في الأصول : أن النص من كتاب اللَّه وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذا احتمل التأسيس والتأكيد معًا وجب حمله على التأسيس ، ولا يجوز حمله على التأكيد ، إلا لدليل يجب الرجوع إليه . ومعلوم في اللغة العربية ، أن العطف يقتضي المغايرة ، فآية « الصافّات » هذه ، دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق ، ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينًا عبّر عنه في كلّها بالعلم لا الحلم ، وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم لا العلم . وأمّا الموضع الثاني الدالّ على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة « هود » ، فهو قوله تعالى : « وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ »( ) ؛ لأن رسل اللَّه من الملائكة بشَّرتها بإسحاق ، وأن إسحاق يلد يعقوب ، فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه ، وهو صغير ، وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب . فهذه الآية أيضًا دليل واضح على ما ذكرنا ، فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلّة القرآنية على ذلك ، والعلم عند اللَّه تعالى( ). وقال أحد الأدباء : واستجاب الله دعاء عبده الصالح المتجرد « إبراهيم » ، الذي ترك وراءه كل شيء ، وجاء إليه بقلب سليم « فبشرناه بغلام حليم ».. هو إسماعيل كما يرجح سياق السيرة والسورة وسنرى آثار حلمه الذي وصفه ربه به وهو غلام . ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد المهاجر المقطوع من أهله وقرابته . لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام ، الذي يصفه ربه بأنه حليم . والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم . بل في حياة البشر أجمعين . وآن أن نقف من سياق القصة في القرآن أمام المثل الموحي الذي يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهيم .. « فلما بلغ معه السعي . قال : يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ، فانظر ماذا ترى . قال : يا أبت افعل ما تؤمر : ستجدني إن شاء الله من الصابرين ».. يا لله ! ويا لروعة الإيمان والطاعة والتسليم .. هذا إبراهيم الشيخ . المقطوع من الأهل والقرابة . المهاجر من الأرض والوطن . ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام . طالما تطلع إليه . فلما جاءه جاء غلاماً ممتازاً يشهد له ربه بأنه حليم . وها هو ذا ما يكاد يأنس به ، وصباه يتفتح ، ويبلغ معه السعي ، ويرافقه في الحياة .. ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيد ، حتى يرى في منامه أنه يذبحه . ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية . فماذا ؟ إنه لا يتردد ، ولا يخالجه إلا شعور الطاعة ، ولا يخطر له إلا خاطر التسليم .. نعم إنها إشارة . مجرد إشارة . وليست وحياً صريحاً ، ولا أمراً مباشراً . ولكنها إشارة من ربه .. وهذا يكفي .. هذا يكفي ليلبي ويستجيب . ودون أن يعترض . ودون أن يسأل ربه .. لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد ؟! ولكنه لا يلبي في انزعاج ، ولا يستسلم في جزع ، ولا يطيع في اضطراب .. كلا إنما هو القبول والرضى والطمأنينة والهدوء . يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب : « قال : يا بني ! إني أرى في المنام أني أذبحك . فانظر ماذا ترى ؟ » فهي كلمات المالك لأعصابه ، المطمئن للأمر الذي يواجهه ، الواثق بأنه يؤدي واجبه . وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن ، الذي لا يهوله الأمر فيؤديه ، في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي ، ويستريح من ثقله على أعصابه ! والأمر شاق ما في ذلك شك فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة . ولا يطلب إليه أن يكلفه أمراً تنتهي به حياته .. إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا ؟ يتولى ذبحه .. وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي ، ويعرض على ابنه هذا العرض ؛ ويطلب إليه أن يتروى في أمره ، وأن يرى فيه رأيه ! إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض المألوف من الأمر . فالأمر في حسه هكذا : ربه يريد . فليكن ما يريد ، على العين والرأس ، وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاماً ، لا قهراً واضطراراً . لينال هو الآخر أجر الطاعة ، وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم ! إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها ؛ وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى .. فماذا يكون من أمر الغلام ، الذي يعرض عليه الذبح ، تصديقاً لرؤيا رآها أبوه ؟ إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه : « قال : يا أبت افعل ما تؤمر . ستجدني - إن شاء الله - من الصابرين ».. إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب . ولكن في رضى كذلك وفي يقين .. « يا أبت ».. في مودة وقربى . فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده . بل لا يفقده أدبه ومودته . « افعل ما تؤمر » .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب . ثم هو الأدب مع الله ، ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال ؛ والاستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية ، ومساعدته على الطاعة : « ستجدني إن شاء الله من الصابرين ».. ولم يأخذها بطولة . ولم يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه ظلاً ولا حجماً ولا وزناً .. إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه ، وأصبره على ما يراد به : « ستجدني إن شاء الله من الصابرين ».. يا للأدب مع الله ! ويا لروعة الإيمان . ويالنبل الطاعة . ويا لعظمة التسليم ! ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. يخطو إلى التنفيذ : « فلما أسلما وتله للجبين ».. ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإيمان . وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان .. إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً . وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً . لقد أسلما .. فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام في حقيقته . ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسليم .. وتنفيذ .. وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم . إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لقد يندفع المجاهد في الميدان ، يقتل ويقتل . ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء آخر .. ليس هنا دم فائر ، ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص ! إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد ، العارف بما يفعل ، المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضى الهادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل ! وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا . كانا قد أسلما . كانا قد حققا الأمر والتكليف . ولم يكن باقياً إلا أن يذبح إسماعيل ، ويسيل دمه ، وتزهق روحه .. وهذا أمر لا يعني شيئاً في ميزان الله ، بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما .. كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ولم يعد إلا الألم البدني . وإلا الدم المسفوح . والجسد الذبيح . والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء . ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا ، وقد حققوا التكليف ، وقد جازوا الامتحان بنجاح . وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما . فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا : « وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا . إنا كذلك نجزي المحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم ».. قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلاً . فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه ، ولو كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هي النفس والحياة . وأنت يا إبراهيم قد فعلت . جدت بكل شيء . وبأعز شيء . وجدت به في رضى وفي هدوء وفي طمأنينة وفي يقين . فلم يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح من دم ولحم ! ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت . يفديها بذبح عظيم . قيل : إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلاً من إسماعيل ! وقيل له : « إنا كذلك نجزي المحسنين » .. نجزيهم باختيارهم لمثل هذا البلاء . ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء . ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء . ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء ! ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى ، ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان . وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم ، الذي تتبع ملته ، والذي ترث نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو تقوم عليها ، ولتعرف أنها الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربها لماذا ؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه . ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئاً ، ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدم ! ثم لتعرف أن ربها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ؛ ولا أن يؤذيها بالبلاء ، إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه ، ولا تتألى عليه ، فإذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام( ) .
وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن الرؤيا الثانية : « إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ ! إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ * قَالَ : يَا بُنَيَّ ! لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ، وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »( ). قال الشعراوي : وهكذا تبدأ قصة يوسف ، حين يقول لأبيه يعقوب - عليهما السلام -: « يا أبت » ، وأصل الكلمة « يا أبي » ، ونجد في اللغة العربية كلمات « أبي » و « أبتِ » و « أبتَاهُ » و« أَبَة » وكلها تؤدي معنى الأبوة ، وإن كان لكل منها مَلْحظ لغوي . ويستمر يوسف في قوله : « يا أبت ! إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً والشمس والقمر رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ »( ). وكلنا رأينا الشمس والقمر ؛ كُلٌّ في وقت ظهوره ؛ لكن حلُم يوسف يُبيِّن أنه رآهما معاً ، وكلنا رأينا الكواكب متناثرة في السماء آلافاً لا حَصْرَ لها ، فكيف يرى يوسف أحد عشر كوكباً فقط ؟ لا بُدَّ أنهم اتصفوا بصفات خاصة ميَّزتهم عن غيرهم من الكواكب الأخرى ؛ وأنه قام بعدِّهِم . ورؤيا يوسف - عليه السلام - تبيِّن أنه رآهم شمساً وقمراً وأحد عشر كوكباً ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين . وهذا يعني أنه رآهم أولاً بصفاتهم التي نرى بها الشمس والقمر والنجوم بدون سجود ؛ ثم رآهم وهم ساجدون له ؛ بملامح الخضوع لأمر من الله ، ولذلك تكررت كلمة « رأيت » وهو ليس تكراراً ، بل لإيضاح الأمر . ونجد أن كلمة : « سَاجِدِينَ » وهي جمع مذكر سالم ؛ ولا يُجمع جَمْع المذكر السالم إلا إذا كان المفرد عاقلاً ، والعقل يتميز بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقل المؤمن هو مَنْ يجعل اختياراته في الدنيا في إطار منهج الدين ، وأسْمَى ما في الخضوع للدين هو السجود لله . ومَنْ سجدوا ليوسف إنما سجدوا بأمر من الله ، فَهُم إذن يعقلون أمر الحق - سبحانه وتعالى - مثلهم في ذلك مَثَلْ ما جاء في قول الحق سبحانه : « إِذَا السمآء انشقت * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ »( ) هذه السماء تعقل أمر ربها الذي بناها . وقال عنها أنها بلا فُرُوجٍ : « أَفَلَمْ ينظروا إِلَى السمآء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ »( ) وهي أيضاً تسمع أمر ربها ، مصداقاً لقوله سبحانه : « وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ »( ). أي : أنها امتلكت حاسة السمع ؛ لأن « أذنت » من الأذن ؛ وكأنها بمجرد سماعها لأمر الله ؛ تنفعل وتنشق . وهكذا نجد أن كل عَالَم من عوالم الكون أُمَم مثل أمة البشر ، ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممَّن يشتركون معه في اللغة ، وقد يتفاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة ، أو من خلال مُترجم ، أو من خلال تعلُّم اللغة نفسها . ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد ، أو لغة النبات ، أو لغة الحيوان ؛ إلا إذا أنعم الله على عبد بأن يفهم عن الجماد ، أو أن يفهم الجماد عنه . والمثل : هو تسبيح الجبال مع داود ، ويُشكِّل تسبيحه مع تسبيحها « جوقة » من الانسجام مُكَوَّن من إنسان مُسبِّح ؛ هو أعلى الكائنات ، والمُردِّد للتسبيح هي الجبال ، وهي من الجماد أدنى الكائنات . ونحن نعلم أن كل الكائنات تُسبِّح ، لكننا لا نفقه تسبيحها ، ولكن الحق سبحانه يختار من عباده مَنْ يُعلِّمه مَنْطِق الكائنات الأخرى ، مثلما قال سبحانه عن سليمان : « وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ : يا أيها الناس ! عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطير .. »( ) وهكذا عَلِمْنا أن للطير منطقاً . وعلَّم الحقُّ سبحانه سليمان لغة النمل ؛ لأننا نقرأ قول الحق : « حتى إِذَآ أَتَوْا على وَادِ النمل قَالَتْ نَمْلَةٌ : يا أيها النمل ادخلوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ : رَبِّ أوزعني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصالحين »( ). إذن : فلكُلِّ أُمَّة من الكائنات لغة ، وهي تفهم عن خالقها ، أو مَنْ أراد له الله - سبحانه وتعالى - أن يفهم عنها ، وبهذا نعلم أن الشمس والقمر والنجوم حين سجدتْ بأمر ربها ليوسف في رؤياه ؛ إنما فهمتْ عن أمر ربها . ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : « قَالَ : يا بني » . وحين يُورِد القرآن خطاب أب لابن لا نجد قوله « يا بني » وهو خطابُ تحنينٍ ، ويدل على القرب من القلب ، و« بُني » تصغير « ابن » . أما حين يأتي القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول « ابني » مثل قول الحق - سبحانه - عن نوح يتحدث عن ابنه الذي اختار الكفر على الإيمان : « إِنَّ ابني مِنْ أَهْلِي »( ). وكلمة « يا بني » بما فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كثيراً فيما سوف يأتي من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه منه . وقول يعقوب ليوسف « يا بني » يُفْهم منه أن يوسف - عليه السلام - ما زال صغيراً ، فيعقوب هو الأصل ، ويوسف هو الفرع ، والأصل دائماً يمتلئ بالحنان على الفرع ، وفي نفس الوقت نجد أيَّ أب يقول : مَنْ يأكل لقمتي عليه أن يسمع كلمتي . وقول الأب : يا بني ، يفهم منه أن الابن ما زال صغيراً ، ليست له ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر بها ما هو المناسب ، وما هو غير المناسب . وحين يفزع يوسف مما يُزعِجه أو يُسيء إليه ؛ أو أي أمر مُعْضَل ؛ فهو يلجأ إلى مَنْ يحبه ؛ وهو الأب ؛ لأن الأب هو الأقدر في نظر الابن - على مواجهة الأمور الصعبة . وحين روى يوسف - عليه السلام - الرؤيا لأبيه ؛ قال يعقوب - عليه السلام -: « قَالَ : يا بني ! لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ على إِخْوَتِكَ »( ). ونفهم من كلمة « رؤيا » أنها رؤيا منامية ؛ لأن الشمس والقمر والنجوم لا يسجدون لأحد ، وهذا ما يوضح لنا دقة اللغة العربية ، فكلمة واحدة هي « رأى » قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رُؤيَ ؛ فرؤيتك وأنت يقظانُ يُقال عنها « رؤية » ؛ ورؤيتك وأنت نائم يُقال عنها « رؤيا » . والرؤية مصدر مُتفق عليه من الجميع : فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما « الرؤيا » فهي تأتي للنائم . وهكذا نجد الالتقاء في « رأى » والاختلاف في الحالة ؛ هل هي حالة النوم أو حالة اليقظة . وفي الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لأن علامة التأنيث إما : « تاء » ، أو « ألف ممدودة » ، أو « ألف مقصورة » . وأخذت الرؤية الحقيقية التي تحدث في اليقظة « التاء » وهي عمدة التأنيث ؛ أما الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التأنيث . ولا يقدح في كلمة « رؤيا » أنها منامية إلا آية واحدة في القرآن حيث تحدث الحق سبحانه عن لحظة أن عُرِجَ به - صلى الله عليه وسلم - فقال : « وَمَا جَعَلْنَا الرؤيا التي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ »( ) ولكن من يقولون : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا القول ؛ فالمعنى هو : إن ما حدث شيء عجيب لا يحدث إلا في الأحلام ، ولكنه حدث في الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها « فتنة للناس » . فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لو كان قد قال إنها رؤيا منامية لما كذَّبه أحد فيما قال : لكنه أعلن أنها رؤيا حقيقية ؛ لذلك عَبّر عنها القرآن بأنها فتنة للناس . وهنا يقول يعقوب - عليه السلام -: « قَالَ : يا بني لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ على إِخْوَتِكَ .. »( ). لأن يعقوب - عليه السلام - كأب مأمونٌ على ابنه يوسف ؛ أما إخوة يوسف فهم غير مأمونين عليه ، وحين يقصُّ يوسف رؤياه على أبيه ، فهو سينظر إلى الصالح ليوسف ويدلُّه عليه . أما إن قصَّ الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الأغيار البشرية يحسدون أخاهم ، وقد كان . وإن تساءل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية ، رأى فيها الشمس والقمر وأحدَ عشرَ كوكباً يسجدون له ؟ نقول : لا بُدَّ أن يعقوب - عليه السلام - قد عَلِم تأويل الرُّؤيا : وأنها نبوءة لأحداث سوف تقع ؛ ولا بُدَّ أن يعقوب - عليه السلام - قد علم أيضاً قدرة إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا ، ولو قالها يوسف لهم لَفهِموا المقصود منها ، ولا بُدَّ حينئذ أن يكيدوا له كيداً يُصيبه بمكروه . فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً ، فما باله بضيقهم إنْ عَلِموا مثل هذه الرؤيا التي يسجد له فيها الأب والأم مع الإخوة . ولا يعني ذلك أن نعتبر إخوة يوسف من الأشرار؛ فهم الأسباط ؛ وما يصيبهم من ضيق بسبب عُلُو عاطفة الأب تجاه يوسف هو من الأغيار التي تصيب البشر ، فهم ليسوا أشراراً بالسَّليقة ؛ لأن الشرير بالسَّليقة تتصاعد لديه حوادثُ السوء ، أما الخيِّر فتتنزَّل عنده حوادث السوء . والمثال على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب في أن يصفع إنساناً آخر صفعة على الخَدِّ ؛ ولكنه بعد قليل يفكر في تصعيد العدوان على ذلك الإنسان ، فيفكر أن يصفعه صفعتين بدلاً من صفعة واحدة ؛ ثم يرى أن الصفعتين لا تكفيان ؛ فيرغب أن يُزيد العدوان بأن يصوِّب عليه مسدساً ؛ وهكذا يُصعِّد الشرير تفكيره الإجرامي . أما الخَيِّر فهو قد يفكر في ضرب إنسان أساء إليه « علقة » ؛ ولكنه يُقلِّل من التفكير في رَدِّ الاعتداء بأن يكتفي بالتفكير في ضربه صفعتين بدلاً من « العلقة » ، ثم يهدأ قليلاً ويعفو عَمَّنْ أساء إليه . وإخوة يوسف وهم الأسباط بدأوا في التفكير بانتقام كبير من يوسف ، فقالوا لبعضهم : « اقتلوا يُوسُفَ ..»( ). ثم هبطوا عن هذه الدرجة المُؤْلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادةِ محبة أبيهم ليوسف ، فقالوا : « أَوِ اطرحوه أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ »( ). وحينما أرادوا أن يطرحوه أرضاً ترددوا ؛ واستبدلوا ذلك بإلقائه في الجُبِّ لعل أن يلتقطه بعض السيَّارة . فقالوا : « وَأَلْقُوهُ فِي غيابت الجب يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السيارة »( ). وهذا يدل على أنهم تنزَّلوا عن الانتقام الشديد بسبب الغيرة ؛ بل إنهم فكروا في نجاته . وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : « لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ على إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً .. »( ). والكيد : احتيال مستور لمَنْ لا تقوى على مُجَابهته ، ولا يكيد إلا الضعيف ؛ لأن القوي يقدر على المواجهة . ولذلك يُقَال : إن كيد النساء عظيم ؛ لأن ضعفهن أعظم . ويُذيِّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « إِنَّ الشيطان لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ »( ). وهذه العداوة معروفة لنا تماماً ؛ لأنه خرج من الجنة ملعوناً مطروداً ؛ عكس آدم الذي قَبِل الله توبته ؛ وقد أقسم الشيطان بعزة الله لَيُغْوِينَّ الكُلَّ ، واستثنى عبادَ اللهِ المخلصين . ولذلك يقول - صلى الله عليه وسلم -: « لقد أعانني الله على شيطاني فأسلم »( ). ويصف الحق سبحانه عداوة الشيطان للإنسان أنها عداوةٌ مُبينة . أي : محيطة . وحين نقرأ القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها يقظة : « ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ »( ) ولم يأت ذِكْر للمجيء من الفوقية أو من التحتية ؛ لأن مَنْ يحيا في عبودية تَحتية ؛ وعبادية فوقية ؛ لا يأتيه الشيطان أبداً . ونلحظ أن الحق سبحانه جاء بقول يعقوب - عليه السلام - مخاطباً يوسف - عليه السلام - في هذه الآية : « فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً »( ) ، ولم يقل : فيكيدوك ، وهذا من نَضْح نبوة يعقوب - عليه السلام - على لسانه ؛ لأن هناك فارقاً بين العبارتين ، فقول : « يكيدوك » يعني أن الشرَّ المستور الذي يدبرونه ضدك سوف يصيبك بأذى . أما « فَيَكِيدُواْ لَكَ »( ) فتعني أن كيدهم الذي أرادوا به إلحاق الشر بك سيكون لحسابك ، ويأتي بالخير لك . ولذلك نجد قوله الحق في موقع آخر بنفس السورة : « كذلك كِدْنَا لِيُوسُفَ .. »( ) أي : كدنا لصالحه . ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : « وكذلك يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ .. » أي : كما آنسَك الله بهذه الرؤيا المُفْرحة المُنْبِئة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك ، فلسوف يجتبيك ربك ؛ لا بأن يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سبباً لصالحك ، ويُعلِّمك من تأويل الأحاديث ما يجعل أصحابَ الجاهِ والنفوذ يلتفتون إليك . ومعنى تأويل الشيء أي معرفة ما يؤول إليه الشيء ، ونعلم أن الرُّؤى تأتي كطلاسم ، ولها شَفرة رمزية لا يقوم بِحلِّها إلا مَنْ وهبه الله قدرة على ذلك ؛ فهي ليست عِلْماً له قواعد وأصول ؛ لأنها إلهامات من الله سبحانه وتعالى . وبعد ذلك تصير يا يوسف على خزائن الأرض ؛ حين يُوجد الجَدْبُ ، ويعُمُّ المنطقة كلها ، وتصبح عزيز مصر . ويتابع الحق سبحانه : « وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ .. »( ) . فكل ما تَمَتَّع به يوسف هو من نعم الدنيا ، وتاج نعمة الدنيا أن الله اجتباه رسولاً . أو أن : « وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ .. »( ). بمعنى ألا تسلب منك النعمة أبداً ؛ ففي حياة يوسف منصبٌ مهم ، هو منصب عزيز مصر ، والمناصب من الأغيار التي يمكن أن تنزع . أو أن : « وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ .. »( ). بأن يصل نعيم دنياك بنعيم أُخْراك . ويتابع الحق سبحانه : « وعلى آلِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَآ على أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »( ). يُذكِّر الحق سبحانه يوسف - عليه السلام - بأن كيد إخوته له لا يجب أن يُحوِّله إلى عداوة ؛ لأن النِّعم ستتم أيضاً على هؤلاء فهم آلُ يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حَفَدة يعقوب ، وسينالهم بعضٌ من عِزِّ يوسف وجاهه وماله ، كما أتمَّها من قبل على إبراهيم الجد الأول ليوسف باتخاذه خليلا لله ، وأتمَّ سبحانه نعمته على إسحق بالنبوة . وهو سبحانه أعلمُ بمَنْ يستحق حمْل الرسالة ، وهو الحكيم الذي لا يترك شيئاً للعبث ؛ فهو المُقدِّر لكل أمر بحيث يكون مُوافِقاً للصواب( ) .
الباحث : محمود بن سعيد الشيخ