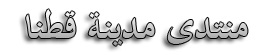قال الدكتور جواد علي : أله بعض الناس الظواهر الطبيعية ؛ لتوهمهم أن فيها قوى روحية كامنة مؤثرة في العالم وفي حياة الإنسان مثل الشمس والقمر وبعض النجوم الظاهرة ، وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السماوية التي لفتت أنظار البشر إليها ، لما في الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وفي حياة الإنسان بصورة مطلقة ، كذلك للقمر أثره في نفس الإنسان بما يبعثه من نور يهدي الناس في الليل ، ومن أثر كبير يؤثر في حس البشر ، فكانا في مقدمة الأجرام السماوية التي ألهها الإنسان ، عبدهما مجردين في بادئ الأمر ، أي دون أن يتصور فيهما ما يتصور من صفات ومن أمور غير محسوسة هي من وراء الطبيعة . فلما تقدم وزادت مداركه في أمور ما وراء الطبيعة ، تصور لهما قوى غير مدركة ، وروحًا ، وقدرة ، وصفات من الصفات التي تطلق على الآلهة . فخرجتا من صفتهما المادية البحتة ومن طبيعتهما المفهومة ، وصارتا مظهرًا لقوى روحية لا يمكن إدراكها ، إنما تدرك من أفعالها ومن أثرهما في هذا الكون . وإذا كانت هذه العبادة قد اقتصرت على الظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة ، فإن هناك توسعًا في هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية ، يصل إلى حد تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك ؛ إذ تصوروا وجود قوى روحية كامنة فيها ، فعبدوها على أن لها أثرًا خطيرًا في حياتهم . ونجد في أساطير الشعوب البدائية أن الإنسان من نسل الحيوان ومن الأشجار أيضًا ، كذلك تجد أمثلة عديدة من هذا القبيل في أساطير اليونان والرومان والساميين( ) . ويجب أن لا يغيب عن بالنا في غمرة الأحداث أن نسجل الملاحظة الهامة التي أشار إليها الدكتور المذكور بقوله : ويتبين من دراسة الأساطير السامية وجود شكل من أشكال التوحيد عند القبائل السامية البدائية ، يمثل في اعتقاد القبيلة بوجود إله لها واحد أعلى ، غير أن هذا لا يعني نفي اعتقادها بتعدد الآلهة . فإننا نرى أن تلك القبائل كانت تعتقد ، في الوقت نفسه ، بالأرواح كأنها كائنات حية ذات أثر وسلطان في مصير هذا الكون . وفي ضمنه الإنسان ، وبآلهة مساعدة للإله الكبير( ). وذهب « رينان » إلى أن العرب هم مثل سائر الساميين الآخرين موحدون بطبعهم ، وأن ديانتهم هي من ديانات التوحيد . وهو رأي يخالفه فيه نفر من المستشرقين . وقد أقام « رينان » نظريته هذه في ظهور عقيدة التوحيد عند الساميين من دراسته للآلهة التي تعبد لها الساميون ، ومن وجود أصل كلمة « أل » « إيل » في لهجاتهم ، فادعى أن الشعوب السامية كانت تتعبد لإله واحد هو « أل » « إيل » الذي تحرف اسمه بين هذه اللهجات ، فدعي بأسماء أبعدته عن الأصل ، غير أن أصلها كلها هو إله واحد ، هو الإله « أل » « إيل »( ). ويقول جواد علي : هنالك أسماء مثل « أل » « إيل » يجد الباحثون صعوبة في الاتفاق على تعيين أصولها ، وضبط معانيها( ) . وتابع حديثه عنها فقال : وقد اقترن اسم « ود » مع « أل » « إيل » في بعض الكتابات العربية الجنوبية ، و« إيل » هو الإله السامي القديم . ولعل في « ود أل » « ود إيل » معنى « حب إيل » ، فتكون « ود » هنا صفة من صفات الإله . وأما « إيل » ، فإنها قد تعني ما تعنيه كلمة « إله » في عربيتنا ، وقد تعني إلهًا خاصًّا في الأصل هو إله الساميين المشترك القديم( ). وقال : وعلى الرغم من ورود « إل » « إيل » بصورة يستنبط منها أنها قصدت إلهًا معينًا خاصًّا ، أي اسم علم ، لا نستطيع أن نقول إن « إل » اسم علم لإله معين مخصوص ، مثل الآلهة الأخرى التي ترد أسماؤها في الكتابات ، ذلك لأن الذين ذكروا « إل » « إيل » في الأعلام المركبة ، أو في مواضع أخرى من كتاباتهم لم يقصدوا كما يتبين من الاستعمال إلهًا معينًا اسمه « إل » « إيل » ، وإنما أرادوا ما نعبر عنه بقولنا « إله » والجمع آلهة . فلفظة « إله » عندنا ليست اسم علم ، وإنما تعبر عن اسم الجلالة دون ذكر اسمه . وهي كذلك عندهم وعند بقية الساميين بمعنى « رب » ، وإله ، و« بعل » عند الأقدمين( ). وقال الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور في حديثه حول ديانة الكنعانيين : فشأنها شأن معظم الديانات القديمة تدور حول تقديس مظاهر الكون وعبادة الطبيعة ، فالجو كان يمثل في نظرهم المعبود الأب ؛ بينما تمثل الأرض المعبودة الأم ، أما الإله الأعلى فكان يعرف باسم « إيل » أو « عليان » ، وهو الذي يوجد مع الإله « بعل » ، وكان يعد إله المطر والمحاصيل ، وزوجته كانت المعبودة عاشرة أو عاثرة أو عشترت ، التي عبدت أحيانًا كالمعبودة الأم ، ومن ألقابها « بعلة » أي سيدة ، وهنا تعد حامية لمكان أو مدينة معينة ، ولقب ملكة السماء ولقب « عنات » ، وهذه كانت تعد صنمًا للحب والحرب( ) . وذهب ابن كثير إلى أن معنى « إيل » : الله في حديثه عن بناء : بيت إيل : أي بيت الله ، وهو موضع بيت المقدس( ) . وحذا حذوه في هذا المعنى عبد العزيز بن صالح فقال : ودل لفظ « إل » أو « إيل » عند العرب الجنوبيين وعند شعوب سامية قديمة أخرى في العراق والشام على معنى الإله . كما استخدم بنفس المعنى في اللغة العربية الشمالية أيضًا( ). أما ابن خلدون فقد كان له رأيًا معاكسًا لتلك الآراء في ذكره يعقوب – عليه السلام – فقال : وفي التوراة أن الله سماه إسرائيل . و« إيل » عندهم كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أسماء الله - عز وجل - وصفاته ، والمضاف أبدًا متأخر في لسان العجم ، فلذلك كان « إيل » هو آخر الكلمة وهو المضاف( ).
الباحث : محمود بن سعيد بن محمود بن يوسف بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ، أبو محمد الشيخ القطناني المكي . مكة المكرمة 26/3/1433هـ
تابع جبل الشيخ – الحلقة الثانية (3)
تابع 2- جبل حرمون
وبالنسبة لجبل الشــيخ في هذه المرحلة الزمنية ، فإن غالبية الأقوام التي سـكنت المنطقة منذ القدم من كنعانيين وفينيقيين وآراميين ... الخ فقد قدسـته وعبدته من دون الله تعالى ، وأقامت لها دور عبادة فوقه . حيث كانت الجبال ينظر إليها على أنها أبناء الله في الأرض ، لذلك اتخذوا عند قمتها أماكن عبادة لهم ، ليكونوا على مقربة من معبوداتهم التي رمزوا لها أخيرًا بـ « أصنامهم » التي عبدوها من دون الله - عز وجل - ومنها : « حرمون ، ولبنون ، وقاسيون ، وقلمون ، وعجلون »( ). فالحوريون أقاموا لهم معبدًا فوق قمته لصنم الهواء عندهم المسمى بـ « شوب » ، والذي أطلق اسمه على أرض المنطقة والجبل المحيطة به « أرض شوبا » ودعوه بمعبد « بعل جاد »( ) ، والسومريون الذين عرفوا هذا الجبل ووصفوه بـ « أرض جبل الأرز " حرمون " ، هي أرض الخالدين » - كما سبق أن ذكرنا - نراهم يصفون ربتهم « إنانا » في إحدى أساطيرهم بأنها ملكة السماء الجليلة التي تسكن « جبال » الأرض الحالية « شوبا » ، وروايتهم عن معبودهم « أوتو » : رب الشمس ، في الأسطورة نفسها ، رغبته في أن يشيد أتباعه معبدًا متساميًا « كالجبل المقدس » ويكون مزاره فيه كالغار . ومرة أخرى نجد أن صلة السومريين بمرتفعات جبل الشيخ كانت متينة ، ودليلنا على ذلك : ما أتت به أسطورتان لملك سومري يدعى إنمركار اعتبرته القوائم السومرية المتأخرة ثاني ملوك الأسرة الأولى في مدينة أوروك بعد الطوفان . وقد روت إحداهما أن الربة « إنانا » قد اصطفته من « بلاد شوبا » الجبلية ، ثم وصفته بأنه المجتبى بالإمارة في البلاد « الجبلية المحصنة » . وأنه الراعي الذي ولدته البقرة الأمينة في « جوف الجبال » . وكل ذلك مما يحتمل معه الربط بين أصول الرجل وأسطورته وبين منطقة ما من مناطق المرتفعات المشار إليها( ) . وجاء الفينيقيون فأطلقوا عليه اسم : « البعل حرمون » بمعنى « الرب حرمون » أو « الإله حرمون » . وهكذا صار هذا الجبل معبودًا مقدسًا يعبدونه من دون الله تعالى ، وقد أقاموا لبعلهم هذا هيكلاً إلى جانب الصخرة الكبيرة التي تكلل قمته ، ولا تزال آثارها ظاهرة حتى اليوم( ). وكان الفينيقيون القدماء يصعدون قمة الجبل أواخر كل صيف بعد موسم الحصاد ويسكبون الماء عليه ، وظلت الطقوس الدينية تقوم فوق الجبل إلى العهد البيزنطي « الروماني » - إبّان انتشار الديانة المسيحية - فالمصادر تذكر أن الوثنيين الذين عبدوا الشمس « شمش » ، ظنوا أنهم يقتربون من معبودتهم الساطعة فوق الجبل ، أكثر من أي مكان آخر( ) . ولا عجب أن يحظى جبـل الـشــيخ : « حرمون » الضخـم المهيـب المرتفع عما حوله بهذه المكانة الرفيعة ، والمكانة العالية ، في نفوس تلك الأمم الضالة عن منهج الله ، فهو يطل ويشـرف على أراضٍ وصحـاري شـاسـعة مترامية الأطراف لا سـيما في الشـرق والجنـوب ، وهو قد شـغل أفكـار الناس المحيطين به الأقربين والأبعدين على السـواء ، فاختلفت نظرتهم إليه بين إعجاب ودهشـة ، ورهبـة ورغبة ، وخـوف ومحبـة ، وعشـق وتقديـس . فمنهم من أعجب بمناظره الخلابة فتغنى به واعتبره مصدر خير وعطاء . ومنهم من هابه وخافه فعبده وقدّســه وأقام له مركز عبادة ، ومنهم من التجأ إليه خوفاً من الأعداء . ومهما تعـددت واختلفـت النظرات إليه ، فقد بقي محط أنظار الناس حوله منذ القدم ، فكان معبوداً لبعضهم ، ومقدســاً لدى بعض آخر ، ومكان عبادة لآخرين . ومما يؤكد ذلك انتشــار المزارات وأماكن العبادة ســواء على الذرى ورؤوس التلال أو في الحنايا والأودية والهضاب والكثير منها ما زال قائماً حتى اليوم ، ومنها ما تعرض للتدمير والخراب بسـبب الحروب والزلازل فتهدم . وبقيت آثار بعضها وزال أثر البعض الآخر( ) .
وفي هذه المرحلة نجد دورًا بارزًا لإبراهيم - عليه السلام - أبو الأنبياء ، الرسول الثاني من أولي العزم من الرسل من بعد نوح - عليه السلام - في تحطيم الأصنام ومحاربة أهل الشرك والباطل ، حتى اعتبره الحق تبارك وتعالى أمة وحده ، قال تعالى : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »( ) ومعنى « أمة » في سياق الآية : قدوة في الخير والعمل والدعوة إلى الله( ) . فقد تطور الشرك والوثنية في عهده إلى عبادة الشمس والقمر والزهرة ، ومظاهر الطبيعة وقواها المتعددة ، وأقيمت الأصنام التي ترمز إليها ، ولقد صور القرآن الكريم هذا التطور ، قال الله تعالى : « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ »( ) . قال أحد المفسرين : إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات.. مشهد الفطرة وهي- للوهلة الأولى - تنكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها . وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق دافق تبحث عن إلهها الحق ، الذي تجده في ضميرها ، ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها . وهي تتعلق في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله ! حتى إذا اختبرته وجدته زائفاً ، ولم تجد فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة الإله وصفته .. ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لها . وهي تنطلق بالفرحة الكبرى ، والامتلاء الجياش ، بهذه الحقيقة ، وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيها للحقيقة التي كانت كامنة من قبل فيها ! .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلى في قلب إبراهيم - عليه السلام - والسياق يعرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآيات القصار .. إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة العقيدة كذلك يصدع بها المؤمن ولا يخشى فيها لومة لائم ولا يجامل على حسابها أباً ولا أسرة ولا عشيرة ولا قوماً .. كما وقف إبراهيم من أبيه وقومه هذه الوقفة الصلبة الحاسمة الصريحة : « وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ : أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً ؟ إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ » .. إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهيم . إنه لم يهتد بعد بوعيه وإدراكه - إلى إلهه - ولكن فطرته السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة - وقوم إبراهيم من الكلدانيين بالعراق كانوا يعبدون الأصنام كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم - فالإله الذي يعبد ، والذي يتوجه إليه العباد في السراء والضراء ، والذي خلق الناس والأحياء .. هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن أن يكون صنماً من حجر ، أو وثناً من خشب .. وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب - وهذا ظاهر من حالها للعيان - فما هي بالتي تستحق أن تعبد ، وما هي بالتي تتخذ آلهة ؟ حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد ! وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم - عليه السلام - للوهلة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطرة التي فطر الله الناس عليها .. ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين ، فتنكره وتستنكره ، وتجهر بكلمة الحق وتصدع ، حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة : « أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً ؟ إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ » .. كلمة يقولها إبراهيم - عليه السلام – لأبيه . وهو الأواه الحليم الرضي الخلق السمح اللين ، كما ترد أوصافه في القرآن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . والعقيدة فوق روابط الأبوة والبنوة ، وفوق مشاعر الحلم والسماحة . وإبراهيم هو القدوة التي أمر الله المسلمين من بنيه أن يتأسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالاً .. وكذلك استحق إبراهيم - عليه السلام - بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف الله لبصيرته عن الأسرار الكامنة في الكون ، والدلائل الموحية بالهدى في الوجود : « وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ » .. بمثل هذه الفطرة السليمة ، وهذه البصيرة المفتوحة وعلى هذا النحو من الخلوص للحق ، ومن إنكار الباطل في قوة .. نري إبراهيم حقيقة هذا الملك .. ملك السماوات والأرض .. ونطلعه على الأسرار المكنونة في صميم الكون ، ونكشف له عن الآيات المبثوثة في صحائف الوجود ، ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب . لينتقل من درجة الإنكار على عبادة الآلهة الزائفة ، إلى درجة اليقين الواعي بالإله الحق .. وهذا هو طريق الفطرة البديهي العميق .. وعي لا يطمسه الركام . وبصر يلحظ ما في الكون من عجائب صنع الله . وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون .. وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه .. وكذلك سار إبراهيم - عليه السلام - وفي هذا الطريق وجد الله .. وجده في إدراكه ووعيه ، بعد أن كان يجده فحسب في فطرته وضميره .. ووجد حقيقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة لما استكن منها في الفطرة والضمير . فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم الصادقة .. إنها رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينة ميسرة ! رحلة من نقطة الإيمان الفطري إلى نقطة الإيمان الوعي ! الإيمان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع والذي لا يكل الله – سبحانه - جمهرة الناس فيه إلى عقولهم وحدها ، فيبينه لهم في رسالات الرسل ، ويجعل الرسالة - لا الفطرة ولا العقل البشري - هي حجته عليهم ، وهي مناط الحساب والجزاء ، عدلاً منه ورحمة ، وخبرة بحقيقة الإنسان وعلماً .. فأما إبراهيم - عليه السلام - فهو إبراهيم ! خليل الرحمن وأبو المسلمين .. « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً . قالَ : هذا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قالَ : لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ » .. إنها صورة لنفس إبراهيم ، وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم - لما يعبد أبوه وقومه من الأصنام . وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله ، وتزحم عالمه .. صورة يزيدها التعبير شخوصا بقوله : « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ » .. كأنما الليل يحتويه وحده ، وكأنما يعزله عن الناس حوله ، ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته ، ومع همه الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره : « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً ، قالَ : هذا رَبِّي » .. وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم - كما أسلفنا - فلما أن يئس من أن يكون إلهه الحق - الذي يجده في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية - صنماً من تلك الأصنام ، فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة ! وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب والنجوم . وما كانت هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكباً .. ولكن الكوكب – الليلة - ينطق له بما لم ينطق من قبل ، ويوحي إلى خاطره بما يتفق مع الهم الذي يشغل باله ، ويزحم عليه عالمه : « قالَ : هذا رَبِّي » .. فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب - من الأصنام - إلى أن يكون رباً ! .. ولكن لا ! إنه يكذب ظنه : « فَلَمَّا أَفَلَ قالَ : لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ » .. إنه يغيب .. يغيب عن هذه الخلائق . فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها.. إذا كان الرب يغيب ؟! لا ، إنه ليس رباً ، فالرب لا يغيب ! إنه منطق الفطرة البديهي القريب .. لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجدلية ، إنما ينطلق مباشرة في يسر وجزم . لأن الكينونة البشرية كلها تنطق به في يقين عميق .. « لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ » .. فالصلة بين الفطرة وإلهها هي صلة الحب ، والآصرة هي آصرة القلب .. وفطرة إبراهيم « لا تحب » الآفلين ، ولا تتخذ منهم إلهاً . إن الإله الذي تحبه الفطرة .. لا يغيب ..! « فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ : هذا رَبِّي . فَلَمَّا أَفَلَ قالَ : لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ » .. إن التجربة تتكرر . وكأن إبراهيم لم ير القمر قط ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه ! فهو الليلة في نظره جديد : « قالَ : هذا رَبِّي » .. بنوره الذي ينسكب في الوجود وتفرده في السماء بنوره الحبيب .. ولكنه يغيب ! .. والرب - كما يعرفه إبراهيم بفطرته وقلبه - لا يغيب ! هنا يحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره وفطرته . ربه الذي يحبه ، ولكنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه .. ويحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه بهدايته . إن لم يمد إليه يده . ويكشف له عن طريقه : « قالَ : لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ » .. « فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ : هذا رَبِّي . هذا أَكْبَرُ . فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ : يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ، وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » . إنها التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءاً وحرارة .. الشمس .. والشمس تطلع كل يوم وتغيب . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد . إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله يطمئن به ويطمئن إليه ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل : « قالَ : هذا رَبِّي . هذا أَكْبَرُ » . ولكنها كذلك تغيب .. هنا يقع التماس ، وتنطلق الشرارة ، ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق ، ويغمر النور القلب ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا يجد إبراهيم إلهه.. يجده في وعيه وإدراكه كما هو في فطرته وضميره .. هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح ..
وهنا يجد إبراهيم إلهه . ولكنه لا يجده في كوكب يلمح ، ولا في قمر يطلع ، ولا في شمس تسطع .. ولا يجده فيما تبصر العين ، ولا فيما يحسه الحس .. إنه يجده في قلبه وفطرته ، وفي عقله ووعيه ، وفي الوجود كله من حوله .. إنه يجده خالقاً لكل ما تراه العين ، ويحسه الحس ، وتدركه العقول . وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهة زائفة ، ويبرأ في حسم لا مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك - وهم لم يكونوا يجحدون الله البتة ، ولكنهم كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة - وإبراهيم يتجه إلى الله وحده بلا شريك : « قالَ : يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » .. فهو الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك . وهي الكلمة الفاصلة ، واليقين الجازم ، والاتجاه الأخير .. فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما تجلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة التي في الضمير .. ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر .. مشهد العقيدة وقد استعلنت في النفس ، واستولت على القلب ، بعد ما وضحت وضوحها الكامل وانجلى عنها الغبش .. نشهدها وقد ملأت الكيان الإنساني ، فلم يعد وراءها شيء . وقد سكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله .. وهو مشهد يتجلى بكل روعته وبهائه في الفقرة التالية في السياق . لقد انتهى إبراهيم إلى رؤية الله – سبحانه - في ضميره وعقله وفي الوجود من حوله . وقد اطمأن قلبه واستراح باله . وقد أحس بيد الله تأخذ بيده وتقود خطاه في الطريق .. والآن يجيء قومه ليجادلوه فيما انتهى إليه من يقين وفيما انشرح له صدره من توحيد وليخوفوه آلهتهم التي تنكر لها أن تنزل به سوءاً .. وهو يواجههم في يقينه الجازم وفي إيمانه الراسخ وفي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه : « وَحاجَّهُ قَوْمُهُ ، قالَ : أَتُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدانِ ؟ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا . أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ؟ وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ ، وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً ؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ » .. إن الفطرة حين تنحرف تضل ثم تتمادى في ضلالها ، وتتسع الزاوية ويبعد الخط عن نقطة الابتداء ، حتى ليصعب عليها أن تثوب .. وهؤلاء قوم إبراهيم - عليه السلام - يعبدون أصنامًا وكواكب ونجومًا . فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه الرحلة الهائلة التي تمت في نفس إبراهيم . ولم يكن هذا داعياً لهم لمجرد التفكر والتدبر . بل جاءوا يجادلونه ويحاجونه . وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وفي ضلال مبين( ).
ولكن ما علاقة هذا كله بجبل الشيخ ؟ في الواقع إن الإجابة تكمن في تسمية جبل الشيخ ببعل حرمون ، فمعنى بعل « الشمس المعبودة من دون الله » ، وهذا يعني أن معنى بعل حرمون « الشمس الإله المقدس » الذي فتن الناس بعبادته ، والذي اعتبر « بعل حرمون » سيد الأبعال كلها ، لأنه يسكن في أعلى جبل في المنطقة كلها ، حيث يعتبر الأقرب إلى الشمس لارتفاعه الشاهق ، ولأن عبادة الأصنام في تلك الفترة كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعبادة الثلاثي : الشمس والقمر والزهرة ، ومن هنا كان إبراهيم – عليه السلام – يواجه نمطًا جديدًا كل الجدة عن النمط الذي واجهه نوح – عليه السلام – شرك أكثر تعقيدًا من شرك قوم نوح الساذج البسيط ، ومن هنا كانت الضرورة لمواجهة هذا الشرك المركب بالحجة والبرهان أولاً ، ثم بتحطيم تلك الرموز التي منحت قوًى خفية من خيالات عبادها ، لإظهار تفاهتها وعدم قدرتها عن نفع نفسها فضلاً عن نفع عابديها من البشر . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن إبراهيم - عليه السلام - بعد محنته وإلقائه في النار هاجر إلى بلاد الشام ليكون على مقربة من مركز الصراع الدائر بين الحق والباطل ، بين التوحيد والشرك ، بين الإسلام والجاهلية ، لذا كان له دور هام فيها ، وكان جزء من هذا الدور في جبل الشيخ . ويحدثنا منيف الخطيب عنه في قوله : إن إبراهيم - عليه السلام – كان له شأن مهم في جبل الشيخ « حرمون » وارتباط وثيق به . تدل على ذلك الآثار المتبقية والمنتشــرة في أماكن كثيرة منه ، التي ما زالت شــاهداً على ذلك ، لاسـيما أنه موجود في قلب منطقة تُـعـُّد مهبط الوحي والرسالات السماوية . وأول ما نبادر إليه في هذا المسـار هو مقام نبي اللـه إبراهيم - عليه الســلام - وهو قائم فوق تلة تكســوها غابة جميلة من أشــجار الســنديان ، ومعروف لدى أبناء المنطقة بـ « مشـهد الطير » أو « مقام الخليل إبراهيم » عليه السلام ، وهو مزار مقدس تقدم له النذور قرب مزرعة « رمتا » إحدى مزارع شــبعا ، وتكاد تكون هذه الغابة الوحيدة المتبقية من غابات وأشـجار جبل الشـيخ الكثيفة التي عبثت بها فؤوس الحطابين والرعاة وأزالتها ، ولكن قداسـة المشـهد حمت هذه الغابة التي ما زالت محافظة على رونقها وقدسـيتها وجمالها . وفي هذا المكان المعروف بالمشـهد أو مشـهد الطير تمت معجزة نبي اللـه إبراهيم – عليه السلام - عندما قسـم الطير إلى أربعة أقســام ، ووزعها على أربعة جبال ، ثم ناداها فأتت إليه تسـعى ، وقد وردت هذه القصة في القرآن الكريم( ). قال تعالى : « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ؟ قَالَ : أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالَ : بَلَى ! وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي . قَالَ : فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »( ). قال أحد المفسرين : والإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان في كل لحظة ، المعروضتان لحس الإنسان وعقله . وهما - في الوقت نفسه - السر الذي يحير ، والذي يلجيء الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري . وإلى أمر آخر غير أمر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز عنه كل الأحياء . إننا لا نعرف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة . ولكننا ندرك مظاهرهما في الأحياء والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق .. قوة الله .. وفي هذا السياق تأتي تجربة إبراهيم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن الذي تشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية . وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم ، المؤمن الراضي الخاشع العابد القريب الخليل .. حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين ! إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره ، وليس طلباً للبرهان أو تقوية للإيمان .. إنما هو أمر آخر ، له مذاق آخر .. إنه أمر الشوق الروحي ، إلى ملابسة السر الإلهي ، في أثناء وقوعه العملي . ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب ولو كان هو إيمان إبراهيم الخليل ، الذي يقول لربه ، ويقول له ربه . وليس وراء هذا إيمان ، ولا برهان للإيمان . ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها ، ويتنفس في جوها ، ويعيش معها .. وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان . وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في القلب الذي يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع : « وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ : رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى . قالَ : أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؟ قالَ : بَلى ! وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي » .. لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ، واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يجلى ويتكشف . ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله . ولكنه سؤال الكشف والبيان ، والتعريف بهذا الشوق وإعلانه ، والتلطف من السيد الكريم الودود الرحيم ، مع عبده الأواه الحليم المنيب ! ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم ، ومنحه التجربة الذاتية المباشرة : « قالَ : فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً . وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » .. لقد أمره أن يختار أربعة من الطير، فيقربهن منه ويميلهن إليه ، حتى يتأكد من شياتهن ومميزاتهن التي لا يخطىء معها معرفتهن . وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن ، ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة . ثم يدعوهن . فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى ، وترتد إليهن الحياة ، ويعدن إليه ساعيات .. وقد كان طبعاً .. ورأى إبراهيم السر الإلهي يقع بين يديه . وهو السر الذي يقع في كل لحظة . ولا يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن ، والتي تنشأ مرات لا حصر لها في كل حي جديد . رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه .. طيور فارقتها الحياة ، وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة ، تدب فيها الحياة مرة أخرى ، وتعود إليه سعياً ! كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه ، إنه قد يراه كما رآه إبراهيم ، وقد يصدق به كما يصدق به كل مؤمن ، ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته . إنه من أمر الله . والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه ، لأنه أكبر منهم ، وطبيعته غير طبيعتهم . ولا حاجة لهم به في خلافتهم . إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على السر المحجوب . وضاعت الجهود سدى ، جهود من لا يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب!( ).
وقال الشعراوي : إن إبراهيم - عليه السلام - يسأل : كيف تُحيي الموتى ؟ أي أنه يطلب الحال التي تقع عليها عملية الإحياء . فإبراهيم - عليه السلام - لا يتكلم في الإحياء ، وإنما كان شكه - عليه السلام - في أن الله سبحانه قد يستجيب لطلبه في أن يريه ويطلعه على كيفية إحياء الموتى ؟ ولنضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - والمثل لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله مُنزه عن أي تشبيه . إن الواحد منا يقول للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث وإلى مُحْدَث وهو البيت الذي تم بناؤه . فهل معرفة الكيفية تدخل في عقيدة الإيمان ؟ لا . ولنعلم أولًا ما معنى : عقيدة ؟ . إن العقيدة هي : أمر معقود ، وإذا كان هذا فكيف يقول : « لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي » ؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال ، وقبل أن يجاب إليه ، لم يكن قلبه مطمئناً ؟ لا ، لقد كان إبراهيم مؤمناً ، ولكنه يريد أن يزداد اطمئناناً ، لأنه أدار بفكره الكيفية التي تكون عليها عملية الإحياء ، لكنه لا يعرف على أية صورة تكون . إذن فالاطمئنان جاء لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة ، ومادمت تريد الكيفية ، وهذه الكيفية لا يمكن أن نشرحها لك بكلام ، بل لابد أن تكون تجربة عملية واقعية ، « فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطير فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ » و « صرهن » أي أملهن واضممهن إليك لتتأكد من ذوات الطير ، ومن شكل كل طير ، حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر . وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير هي : الغراب ، والطاووس ، والديك ، والحمامة ، وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة . « ثُمَّ اجعل على كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادعهن يَأْتِينَكَ سَعْياً » ، فهل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أو اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض لهذه الحكاية ، فإما أن يكون الله قد قال له الكيفية ، فإن أراد أن يتأكد منها فليفعل ، وإما أنه قد تيقن دون أن يجري تلك العملية . إن القرآن لم يقل لنا هل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أم لا ؟ والحق يقول مخاطبًا إبراهيم بخطوات التجربة : « ثُمَّ ادعهن يَأْتِينَكَ سَعْياً » وكان المفروض أن يقول : يأتينك طيرانًا . فكيف تسعى الطيور؟ إن الطير يطير في السماء وفي الجو . لكن الحق أراد بذلك ألا يدع أي مجال لاختلاط الأمر فقال : « سعيًا » أي أن الطير سيأتي أمامه سائرًا ، لقد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعي كي يتأكد منها سيدنا إبراهيم ، إذن فلكي تتأكد يا إبراهيم ويزداد اطمئنانك جئنا بها من طيور مختلفة وأنت الذي قطعتها ، وأنت الذي جعلت على كل جبل جزءًا ، ثم أنت الذي دعوت الطير فجاءتك سعيًا . وهنا ملحظية في طلاقة القدرة ، وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود وهو الله سبحانه لمنكر واجب الوجود وهو الإنسان ، هذا له قدرة ، وذاك له قدرة ؛ إن قدرة الله هي قدرة واجبة ، وقدرة الإنسان هي قدرة ممكنة ، وقدرة الله لا ينزعها منه أحد ، وقدرة الإنسان ينزعها الله منه ؛ فالإنسان من البشر ، والبشر تتفاوت قدراتهم ؛ فحين تكون لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له ، أي عاجز . ويستطيع القادر من البشر أن يعدي أثر قدرته إلى العاجز ؛ فقد يحمل القادر كرسيًّا ليجلس عليه من لا يقدر على حمله . لكن قدرة الحق تختلف . كأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول : أنا أعدي من قدرتي إلى من لا يقدر فيقدر، أنا أقول للضعيف : كن قادراً ، فيكون . وهذا ما نفهمه من قوله سبحانه لإبراهيم : « ثُمَّ ادعهن يَأْتِينَكَ سَعْياً » . إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن كيفية الإحياء ، ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادي الطير، فيأتي الطير سعيًا . إن الحق يعطي القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيأتي الطير سعيًا . وهذا هو الفرق بين القدرة الواجبة ، وبين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يعديها أحدٌ لخالٍ منها ، ولكن قدرة واجب الوجود تُعديها إلى من لا يقدر فيقدر ... بإذن من الله . وكذلك كان الأمر في تجربة سيدنا إبراهيم ، لذلك قال له الحق : « واعلم أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ » . إن الله عزيز أي لا يغلبه أحد ، وهو حكيم أي يضع كل شيء في موقعه . وكذلك يبسط الحق قصة الحياة وقصة الموت في تجربة مادية ؛ ليطمئن قلب سيدنا إبراهيم ، وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدي إلى ذلك ... إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال ، ثم يعيده بعد الموت ، وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يظن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة في خلقه ، وهو الغالب في ملكه ، وهو الحكيم في فعله وتقديره( ).
وعلى هذا الجبل « جبل الشيخ » تم الوعد الإلهي لإيراهيم - عليه السلام – كما تقول التوراة ، لما مر بأرض الكنعانيين ظهر له الرب وقطع معه ميثاقًا حسب ما جاء في سفر التكوين : « لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات »( ). قال الكلبي : صعد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - جبل لبنان فقيل له : أنظر فما أدركه بصرك فهو مقدس ، وهو ميراث لذريّتك من بعدك( ). وجبل لبنان هو تسمية أخرى لجبل الشيخ سيرد تفصيلها – فيما بعد - ولا شك أن ذرية إبراهيم - عليه السلام - تشمل بني إسرائيل والعرب من بني إسماعيل ، وقد تحقق هذا الوعد بسكنهم جميعًا في هذه الأرض !! ولا يوجد اختصاص لبني إسرائيل بهذا الوعد دون بني إسماعيل « العرب » . وهذه النقطة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح ، فإن الذين وعدوا هم الأمة المسلمة من نسل إبراهيم - عليه السلام - وهم الذين سكنوا هذه الأرض المقدسة ومنها جبل الشيخ ، سواء كانت هذه الأمة المسلمة من ذرية يعقوب بن إسحاق - عليهما السلام - أو من ذرية إسماعيل - عليه السلام – وهذه إشارة لطيفة نستفيدها من وصف الحق لها بـ « الأرض المقدسة » ، والشعب الذي يسكنها لا بد أن يكون مقدسًا أي طاهرًا من أدران الشرك والوثنية ، مسلمًا موحدًا عابدًا لله تعالى محققًا لشروط استخلافه فيها وسكناه بها !! وإلا سيطرد منها كما طرد كل العصاة والخارجين عن أمر الله ، فهؤلاء ليس لهم كرامة عند الله ، وهذه الأرض جعلها الله لأهل كرامته وطاعته ، أما الذين عصوا أمره وخرجوا عن نهجه فقد كتب عليهم التيه في الأرض ، وإذا كانت الجماعة الأولى في عهد موسى - عليه السلام – قد تاهت أربعين سنة ، فإن تيه العصاة الخارجين عن شرعه ومنهجه من بعد ذلك مشاهد متكرر في واقع الحياة .
ويشاء الله تعالى أن تكون أرض جبل الشيخ « حرمون » بمفهومه الواسع شاهدة على أكبر صنم عبد في بلاد الشام وبلاد الرافدين وآسيا الصغرى وجزيرة العرب وإيران ووادي النيل وكثير من جزر البحر المتوسط وبعض السواحل الجنوبية الأوربية وشمال أفريقيا ، وهو الصنم « بعل » الذي بني له معبد كبير في بعلبك ، غرب جبل حرمون ، وسنتطرق إلى دراسته بشيء من التفصيل في الفصول القادمة ، ويرسل الله إلى عبَّاده من دون الله رسولاً هو إلياس – عليه السلام – كما ذكر في القرآن الكريم . هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يحتمل أن تكون المغارة المذكورة سابقًا باسم « مغارة إيليا » في جبل الشيخ تشير إلى رسول الله : « إيليا » المذكور بهذا الاسم في العهد القديم ، وهو المذكور في القرآن الكريم باسم الياس – عليه السلام – وتعبده فيها ، أو التجائه إليها ليختفي عن أنظار قومه الذين عادوه ووقفوا حائلاً بينه وبين تبليغ رسالته التوحيدية ، لقربها الواضح من مكان دعوته لتوحيد الله عز وجل ، والأحداث التي تتالت عليه ، والجبل -كما ألمحنا - يعتبر ملجأ آمنًا حصينًا لمن لجأ إليه ، لطبيعة تضاريسه ، ووعورة مسالكه ، وسهولة الاختفاء فيه عن أعين الأعداء ، وسهولة الدفاع عن النفس فيه ، كما كان يفضله كثير من الزهاد والنساك والرهبان في خلواتهم وعبادتهم . وقد تكون المغارة نفسها معبدًا لـ « إيل = الله » في صورته التوحيدية ، أو بعد ملابستها للشرك والوثنية كما ذكر أحد الباحثين( ) .
وجاء رسول الله – عيسى – عليه السلام – وهو من أولي العزم من الرسل ، ليكمل مسيرة من قبله إلى جبل الشيخ ، وصعد عليه كما صعد إبراهيم – عليه السلام – من قبل ، وفي ذلك دليل آخر على قدسيته ، ومكانته ، ودعا له : أن لا يعدو سبعه ، ولا يجدب زرعه( ). وذلك أن المسيح - عليه السلام – كما يقولون - صعد وثلاثة من تلامذته من بانياس على الجبل العالي ، بعد زيارته لمدينة بانياس ، وتجلى فوقه بصورة نورانية ، ضاهى فيها الضوء المنبثق من وجهه وثيابه نور الشمس ، ثم عاد ليشفي صبيًا . وقد جاء في النص الإنجيلي : « أخذ يسوع بطرس ويعقوب وأخاه يوحنا وانفرد بهم على جبل عال ، وتجلى بمشهد منهم ، وأشرق وجهه كالشمس ، وصارت ثيابه بيضاء كالنور ، وبينما هو يتكلم ظللتهم سحابة مضيئة »( ). ولهذا حظي جبل الشيخ باهتمام النصارى بصورة كبيرة متزايدة ، وسموا يوم صعوده بيوم التجلي ، وصار كتاب التاريخ الكنسي المسيحي يتحدثون عن مسألة تجلي السيد المسيح على جبل حرمون . ونحن نرى اليوم بعض المسيحيين القاطنين في القرى اللبنانية القريبة من الجبل ، وخاصة راشيا الوادي ، يحتفلون كل عام بعيد التجلي بالمسير إلى قمم جبل الشيخ ، وإقامة الطقوس هناك( ).
وهذا ما جعل كثيرًا من النصارى يقومون بزيارته ولو من أماكن بعيدة ، حيث لا يزالون في أواخر فصل كل صيف يصعدون إلى أعلاه ويحتفلون ويقولون : لا تزال قمة جبل الشيخ تشهد الاحتفال بعيد « يوم التجلّي » . وهذا الاحتفال يتم عادة في « 5- 6 » من شهر آب ، وذلك في بقايا المعبد الكنعاني المعروف باسم قصر شبيب ، وذلك في إطار الرحلة السنوية التي تنظمها بلدية راشيا إلى قمة الجبل ، قاطعة مسافة 60 كيلو مترًا . وقد تحولت هذه الرحلة التي تستغرق سبع ساعات من المسير صعودًا إلى تقليد ، كما عبّرت دعد مالك « نحاول من خلال المشاركة السير على خطى السيد المسيح الذي صعد إلى قمة الجبل للتجلي » . وفي القمة تقام الصلاة ، وتحيي قداسًا مع ساعات الفجر الأولى عند قوات الأندوف « UN » المتمركزة عند القمة . وفي كل عام يشهد جبل حرمون حركة نشطة تحاول إخراجه من عزلته التي فرضتها قساوة الطبيعة على امتداد فصول السنة . حيث تقيم بلدية راشيا مخيمًا مركزيًا على ارتفاع نحو 2200 م مجهّزًا بما يلزم من وسائل ضرورية لراحة مئات الزوار( ). وقد أعد النصارى مؤخرًا في راشيا مشروعًا لإقامة كنيسة لهم فوق إحدى قمم جبل حرمون يدعونها بـ « كنيسة التجلي » ، وذلك لإقامة قداديسهم فيها كل عام( ). وفي الحقيقة فإن الفترة الممتدة من أوائل تموز حتى منتصف أيلول ، تعدّ الأنسب في موقع القصر ، قبل حلول الشتاء وتساقط الثلوج وتدني درجات الحرارة ، لذلك اختارت بلدية راشيا الوادي والجمعيات الأهلية في المنطقة الاستعداد لرحلة تقام سنوياً للراغبين في الصعود إلى قمة جبل الشيخ في 5 و 6 آب من كل عام( ) . وسبب اختيار هذين اليومين هو اختيار لتقليد بعض الكنائس النصرانية في لبنان التي عينت يوم الـ 6 من آب للاحتفال بالعيد من كل عام( ) .
وأخيرًا جاء الفاتحون الأولون من صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ليرفعوا رايات التوحيد عالية مرفرفة على جبل الشيخ والأرض المقدسة إلى يومنا هذا ، وهي تحمل الطهر لهذا الجبل من دنس الشرك والوثنية ، وتسوق البركة إلى قاطنيه إلى يومنا هذا ، وما تسميته في العصور الحديثة بجبل الشيخ إلا رمز يدل على استمرارية هذا التوجه نحو التوحيد ، وانتصار الإسلام الدين الإلهي الذي ارتضاه الله للبشرية منذ نزول آدم – عليه السلام - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، قال تعالى : « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ »( ).
4- الوثنية الأخيرة : قال الألباني : يا حسرة على هؤلاء المسلمين !! لقد كان المفروض فيهم أن يكونوا دعاة لجميع الناس إلى دين التوحيد ، وسببًا لإنقاذهم من الوثنية وأدرانها ، ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم ، واتباعهم أهواءهم ، عادوا مضرب مثل للوثنية من قبل المشركين أنفسهم ، فصاروا يصفونهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على القبور . ثم قال : وقد يظن بعض الناس خاصة من كان منهم ذا ثقافة عصرية أن الشرك قد زال وأنه لا رجعة له بسبب انتشار العلوم واستنارة العقول بها . وهذا ظن باطل فإن الواقع يخالفه إذ أن المشاهد أن الشرك على اختلاف أنواعه ومظاهره لا يزال ضاربا أطنابه في أكثر بقاع الأرض ولا سيما في بلاد المغرب عقر دار الكفر وعبادة الأنبياء والقديسين والأصنام والمادة وعظماء الرجال والأبطال ومن أبرز ما يظهر ذلك للعيان انتشار التماثيل بينهم وأن مما يؤسف له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشر رويدًا في بعض البلاد الإسلامية دون أي نكير من علماء المسلمين .. على أننا لو فرضنا أن الأرض قد طهرت من أدران الشركيات والوثنيات على اختلاف أنواعها فلا يجوز لنا أن نبيح اتخاذ الوسائل التي يخشى أن تؤدي إلى الشرك لأننا لا نأمن أن تؤدي هذه الوسائل ببعض المسلمين إلى الشرك بل نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان إن لم يكن قد وقع الآن . وقال عمر بن سليمان الأشقر تحت عنوان : « عودَة البشريَة إلى الجاهليَة وَعبادة الأوثان » : فإذا درس الإسلام ، ورفع القرآن ، وقبضت الريح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان - عادت البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشد ، فتطيع الشيطان ، وتعبد الأوثان . وقد حدثنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما يكون بعد موت المسيح - عليه السلام - في آخر الزمان ، ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم : « ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام ، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ، حتى لو كان أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه ، حتى تقبضه » قال : سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : « فيبقى شرار الناس في خفة الطير، وأحلام السباع ، لا يعرفون معروفاً ، ولا ينكرون منكراً ، فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : ما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان ، وهم في ذلك دارةٌ أرزاقهم ، حَسَنٌ عيشهم ، ثم ينفخ في الصور » الحديث ( ).
وإليك بعض النصوص الواردة في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسل